أركان النص المسرحي
تأكيدها وإعادة نظر فيها
المقدمة :-
منذ فجر البشرية والإنسانُ يحب الحكايات. وما إن يدخلِ الطفل عالم المدركات، حتى تأخذ (كان ياما كان) صدىً رائعاً في نفسه وتفعل فعل السحر في تفكيره وإثارة انتباهه وخياله، وتظل تفعل في الإنسان هذا الفعل المثيرَ مهما بلغ من درجات العلم ومهما حُرِمَ منه. وسواءٌ كان شاباً فتياً أم كان هرماً يشكو العلل والأمراض، فإن الحكاية تجذب انتباهه وتسرقه أثناء سردها عن نفسه وأحواله. ويمكنك أن تتثبت من فعل الحكاية في الإنسان بأبسط الطرق وبشكل واقعي لا يحتمل الجدل أو المناقشة أو كثرة التحليل والتنظير. وذلك بأن تراقب مجموعة من الناس مجتمعين في مكانٍ ما لسبب ما كأن يكون حفلة عرس أو مناسبة تعزية أو جلسةَ مصالحة بين زوجين مختلفين. فما إن يأخذ أحدُ الموجودين بسرد (حكاية طريفة) حتى تجد الحاضرين - وهم من أعمار مختلفة ومن درجات ثقافية مختلفة - وقد انتبهوا عن الموضوع الذي اجتمعوا من أجله وانساقوا وراء الحكاية. أفما رأيتَ مرةً مجموعةَ المعزّين، مثلاً، يخلعون عن وجوههم ملامحَ الحزن الصادق أو المفتعل حين تُروى أمامهم حادثةٌ مثيرة أو قصة طريفة؟ ولو تمعنتَ في وجوههم لوجدت اللهفة إلى السماع تكون بمقدار جودة الراوي وحسن سرده للحكاية أو الحادثة. ولو تمعنت في وجوههم أكثر لوجدت أن درجة اللهفة واحدة متشابهة رغم اختلاف الأعمار والثقافات. فكأن الحكاية قادرةٌ قدرةً فائقةً على صهر مستمعيها في بوتقة واحدة تحوِّلهم إلى كتلة واحدة في لحظة الاستماع إليها، وقادرة على أن تغرس في نفوسهم أثرها ومغزاها بدرجة واحدة من القوة. حتى إذا تفرقوا عن مجلس الحكاية وعاد كلٌّ منهم إلى سياق حياته، عاد كلٌّ منهم إلى تحليل ما سمع. وعند ذاك يظهر تأثير الأعمار والثقافات في اتخاذ المواقف مما سمعوه وتلهفوا لتلقّيه. وأعتقد أن هذه اللهفة الإنسانية الفطرية لسماع الحكايات هي الدافع الأساسي لنشأة جميع فنون القول. فلم تكن فنونُ الأدب في عصور البشرية المختلفة وعند جميع الأقوام، شعراً أم قصة أم مسرحية، إلا مجموعةً من الحكايات التي يرويها الأدباء كلٌّ حسب طريقته. ويتلقاها المتلقون كلٌّ حسب ثقافته ومخزونه المعرفي.
ولم يكن الشعر - وهو أقدم فنون القول - إلا وعاءً للحكايات التي انبثقت عنها الملاحم والأقاصيص الشعبية. فلما امتد الزمن بالأقوام وُجِد عند كلٍّ منها أشكال خاصة بهم يتحلَّقون حولها في مجالس سمرهم. وكانت كل قصة تُروى في عصر من العصور عند أبناء القوم الواحد، تحمل خصائص ذلك العصر كما تحمل نزعاته الاجتماعية والسياسية، وتكرِّس قيماً يفتخرون بها ويحبون أن يغرسوها في نفوس أبنائهم حتى ينشؤوا عليها. فمثلاً، نجد أن الشجاعة والشهامة والكرم والصدق والوفاء ونجدة الملهوف - وما يتفرع عنها من معان إنسانية - هي المبادئ الأساسية التي دارت حولها جميع الحكايات التي رواها العرب منذ أقدم عصور الجاهلية حتى اليوم.
وكان القرآن أهم مصادر الحكايات عند العرب فيما اصطلح الدارسون على تسميته (قصص القرآن). وكانت هذه القصص واحدةً من أبرع وسائل الدعوة الإسلامية. ولعل أسلوب سرد هذه القصص من أبرع ما عرفه تاريخ الحكايات في العالم. ففي كل واحدة منها غرابةٌ تشدُّ انتباهَ القارئ أو المستمع. وفي كل واحدة منها "مغامرة" تثير عند أبطالها مختلفَ المشاعر الإنسانية المتراوحة بين الألم والخوف وبين الفرح والسعادة. ففي قصة يوسف تبدأ الإثارةُ منذ أن رأى أبوه الحلمَ الغريب. ثم تزداد الإثارة توهجاً حين يرميه إخوتُه في البئر ثم حين تحمله القافلة إلى مصر. ثم تمضي في حبكةٍ فاتنة وهي تصعد به من السجن إلى منصبٍ رفيع في بلاط فرعون. ثم تنتهي بأجمل النهايات حين يرتدُّ إلى أبيه نورُ عينيه. وقصةُ مريم أشدُّ غرابة وهي تستقبل الروحَ القدس الذي ينبئها بحمْلٍ غريب. وما أجمل ما ينتابها من مشاعر الخوف بهذا الحمل. أما لحظة ولادتها للنبي المرتقب فتبلغ أشد مواضع الحكاية توتراً. ثم تبلغ الحكاية ذروتها حين تشير إلى وليدها فيتكلم. ولو رحنا نستعرض قصص القرآن لوجدنا في كل واحدة منها كميةً وافرة من إدهاش القصِّ المثير الفاتن. ألم يقل القرآن، وقد صدق فيما قال، (نحن نقص عليك أحسن القصص)؟ وزاد القرآن على هذه الإثارة في مفردات حكاياته أنه كان يغير أسلوب سردها وطريقةَ تركيب وقائعها. فيأتي بها كاملةً مرةً. ويأتي بقسمها الأول مرة ثانية دون أن يتجاوزه إلى قسمها الثاني. ويأتي بقسمها الثاني أو جزئها الأخير مرة ثالثة. وفي كل مرة كان يُبرِزُ جانباً مثيراً من الحكاية أو يعيد صياغة الإثارة. فكأنه كان يصور المشهد الواحد من زاوية جديدة في كل مرة. وفي كل مرة كان يحشد في كل مشهد (لقطة) ساخنةً مثيرة. وإذا كانت غايةُ القرآن من (أحسن القصص) هذه أن يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، فإنه سعى إلى أن أن يحقق هذه الغاية بجودةٍ رفيعةٍ في سرد الحكايات وبتفننٍ مذهل في أساليب سردها.
ثم كانت سيرةُ الرسول الكريم صلوات الله عليه - وهي أهم حكاية
عربية - حافلةً بالقيم الأخلاقية الرفيعة التي اتصف بها النبي من ناحية وأكدها رواةُ السيرة من ناحية ثانية. لكن هذه السيرة حافلةٌ أيضاً بكل ما هو مثير من الأحداث والوقائع التي تشكل - بمصطلحنا اليوم - مجموعةً من المغامرات الشديدة الصعوبة، والتي تجعلنا حتى اليوم نستعيدها بذلك الشوق المتلهف سواءٌ كنا متدينين أم لم نكن كذلك. ألا يعتزُّ العربي - مسلماً كان أم غير مسلم - بقصة نشأة النبي المثيرة وبحكايته الدرامية مع خصومه من أبناء مكة وهم الأدنَوْن قرابةً منه؟ ألا تثير العربيَّ تلك الغزواتُ التي رُوِيت لنا بأبهى صورة من صور القصِّ وجعلت النبي بطلاً شجاعاً وهو كذلك بحق، فكانت الفتنةُ به وبشخصه وبشجاعته؟ ألا نجد في غزوة حنين، مثلاً، واحدةً من أمتع القصص وأكثرها مدعاة للإثارة؟ فجيش المسلمين العرمرم كان يسير قوياً مدججاً بالسلاح مغتراً بقوته. وإذا به يشتته نفرٌ من رماة السهام. وإذا به يتبدد في لمحة عين. وإذا بقائد الجيش يصبح وحيداً. وإذا بعمِّه العباس يستنجد بقدامى المؤمنين. وإذا بهؤلاء الشجعان الصادقين يلتفّون من جديد حول القائد المهزوم. وإذا بهؤلاء القلة يستعيدون زمام المعركة. وإذا بأولئك المنتصرين يلقَوْن أشنعَ هزيمة إذ تُسبى نساؤهم وتُحتَجَنُ أموالهم ويُقضى على أكثرهم بالفناء. ألا يجد القارئ - عربياً كان أم غير عربي - حكايةً من أمتع الحكايات في هذه الغزوة المثيرة المدهشة؟
وإذا كانت سيرة الرسول الكريم واحدة من أبرع حكايات العرب، فقد كان لهم حكايات أخرى مثيرة أيضاً ومحمَّلة بالعبرة والمغزى التي يحبون أن ينشأ أبناؤهم على ما فيها من أخلاق اعتبرها العربُ حميدةً يفتخرون بها. ولعل (قصص العرب) كانت المادة الرئيسية في مجالس السمر وفي بلاطات الخلفاء والأمراء في طول الأرض العربية وعرضها من قرطبة في الأندلس الغربي إلى سمرقند وبخارى في شرق تلك الأرض القديمة. وكان العرب طوال العصور ينتجون الحكايات التي نصنِّفُها اليوم بأنها أساطير أو ملاحم أو حكايات شعبية أو سِيَرٌ للقبائل أو قصص للعشاق. وبغض النظر عن التسميات الاصطلاحية التي وضعها النقد الأدبي، فإن مختصر هذا الكلام أن الحكاية كانت زاداً للإنسان العربي في رحلة الحياة التي يعيشها.
ولم يكن أمرُ الإنسان غير العربي مختلفاً عن أمر العربي. وقد بدأت الحكايات عند مختلف الأقوام لبوساً للأفكار الدينية. ولعلها كانت الوسيلة الوحيدة لإقناع الناس بالمفاهيم الدينية مما يدل على عمق تمسك وتأثر الإنسان بالحكاية. فلبوذا قصة طريفة مدهشة. وقصة كونفوشيوس لا تقل طرافة عن قصة بوذا. ولم تكن أديان أوروبا قبل المسيحية أكثر من مجموعة من الحكايات المدهشة التي يجتمع فيها الغيبي الأسطوري بالواقعي. وإذا كنتَ اليوم لا تؤمن بمعتقداتها، فإنك تظل مفتوناً بأحداثها ووقائعها. فهكذا فُطِرَ الإنسان ولن تستطيع لفطرته تبديلاً.
في هذا التاريخ العريق للحكايات كان الشكلُ الأمثلُ لسردها أن تُروى أمام جمهورٍ يسمعها مباشرة من فم الراوي. وكان الرواة يلبُّون نزعةَ سماع الحكايات عند الإنسان بتشويق يخلق عند مستمعيهم حالةً من الاندغام الجماعي الحار المتلهف الذي يلتذُّ المستمعُ حين يشعر به. وهذا الاندغام الجماعي يصهر المتلقين في حالةٍ من التوحُّد اللذيذ ومن المشاركة الوجدانية العامة التي تجعلهم وكأنهم يشربون الحكاية المرويَّةَ أمامهم بنشوة فائقة. فإذا انفضَّ مجلسُ الحكاية أخذوا يستعيدون أحداثَها ويتبادلون الرأيَ في وقائعها، ويتفقون أو يختلفون في تقييمها بين مؤيد ومعارض. فإذا حدث هذا - وكان هذا يحدث دائماً - شعروا كأنهم شاركوا في صَوْغِ الحكاية وفي قصِّها. وتلمَّست قلوبُهم وعقولُهم أحداثَها بحرارةٍ لا يمكن أن تتولد مع الحكاية المقروءة.
وإذا كان الشعر، بعد أن ترك قصَّ الحكايات، يتشارك مع الحكاية في أنه يُروى أمام الناس، فقد ظل مترافقاً في النشأة والتأثير مع الحكايات. ومن أجواء رواية الحكايات والأشعار أمام الناس وُلِدت المسرحية. أما الرواية التي يقرؤها القارئ وحده ويستمتع بها وحده ولا يتشارك في التمتع بها مع غيره، فقد تأخرت ولادتها قروناً كثيرة. وإذا كان الدارسون يردّون وجود (الرواية) في أشكالها الأولى إلى بداية القرن السادس عشر في أوروبا وإلى أواسط القرن العاشر الميلادي عند العرب، فهم يؤكدون أيضاً أنها لم تكن في حقيقتها إلا تجميعاً للحكايات التي كانت تُروى في المجالس. فقد وجدوا أن (الحبكات الملحمية في العصور القديمة وفي عصر النهضة كانت تُبنى على التاريخ الماضي أو ما سلف من خرافة)([1]). وهذا الأمر نجده تماماً في الرواية العربية. فقد جُمِعَت عندهم مما كان يروى في المجالس. ومن ذلك، كما نعرف، حكاياتُ ألف ليلة وليلة، وسيرةُ عنترة والزير سالم والظاهر بيبرس وعشراتٌ غيرها من الحكايات المروية. وكما بدأ تجميع الحكايات العربية المروية في روايات مكتوبة بعد انتشار "التدوين" منذ أواسط العصر الأموي، فإن تجميعها في أوروبا بدأ أيضاً عندما أخذ عدد القراء يزداد عن عدد المستمعين. و(كل النقاد من هيغل حتى جون هالبرين مجمعون أن الرواية الحديثة بدأت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر).([2])
ولم تستطع الرواية أن تنفصل بنفسها وتخترعَ أحداثَها بنفسها دون الاعتماد على مرويّات الرواة إلا مع بداية القرن التاسع عشر عندما أخذ الأدباء يستمدون شخصياتِ رواياتهم وأحداثَها من الواقع. وهي التي يسميها الدارسون "الرواية البورجوازية". (فقد كان ممتعاً بالنسبة إلى جمهور بورجوازي أن يودَّ التعرُّفَ على نفسه في شخصية البائع العادي بين عددٍ من شخصيات الرواية)([3]). ولذلك خرج لوكاتش (بأطروحته المشهورة بأن الرواية ليست إلا ملحمة البرجوازية التي ظهرت على مسرح التاريخ في أعقاب النهضة الأوروبية، وبالتحديد بعد الثورة الصناعية التي جعلت منها الطبقةَ السائدة في المجتمعات الأوروبية)([4]).وعند ذلك أصبحت شكلاً أدبياً جديداً يبتكر موضوعاتٍ جديدة. وتأخر ظهورها عند العرب إلى بداية القرن العشرين. وذلك عندما أخذ الأدباء العرب يخترعون أحداثاً واقعية. وإذا كانت نشأة الرواية الحديثة في أوروبا تستند إلى البورجوازية التي كانت ناهضةً حتى سُمِّيت الروايةُ باسمها، فإن أول رواية عربية وهي (زينب) دارت بين أوساط الفلاحين لأن الإقطاع كان ما يزال سائداً في الوطن العربي في بداية القرن العشرين، وكان الفلاح يشكل العمود الفقري للاقتصاد.
من هذه الإشارات السريعة لتاريخ (القصة) التي هي مدار الحكايات في تاريخ البشر نصل إلى نقطتين لا يمكن فهم (القصة في المسرح) من دونهما.
أولاهما أن الرواية الجامعة للحكايات القديمة ثم المبتَكَرة التي أحلَّت الواقعَ محلَّ الحبكات القديمة، قضتا نهائياً على مجالس السمر التي تُروى فيها الحكايات ويتولد فيها ذلك التشاركُ الوجداني الذي أشرنا إليه. فأفقدت الحياةَ واحداً من أهم تجلياتها وهو (اللقاء الجمعي) الذي يُثبت تاريخُ البشرية أنه مطلبٌ لا يمكن للبشر أن يستغنوا عنه. ودليل ذلك أن جميع الأديان منذ القديم حتى اليوم، تقوم العبادات الأساسية فيها على (التجمع في مكان حاشد) لأن هذا التجمع يخلق وجداً دينياً عميقاً في نفوس الناس. وقد ورث السياسيون والحكماء والمصلحون هذا الإرثَ الديني فاعتمدت دعواتهم على تجميع الناس في أماكن حاشدة تخلق لهم شعوراً جمعياً يساعد دعاواهم في الانتشار لأنها تحمل حماسةَ التجمع ووجدانيةَ اللقاء الجمعي. وبهذا الشكل ندرك مدى الخسارة الإنسانية الوجدانية والفكرية التي أوقعتها الروايةُ الجامعة للحكايات القديمة.
وثانيتهما أن الرواية الحديثة التي تخترع شخصيات واقعية وتستمد أحداثها من الواقع وتنحو نحو تصوير مكنونات الفرد الواحد، قضت على إمكانية خلق أجواء الأساطير والبطولات الخيالية. كما قضت على شيء أهم هو (بطولات الجماعات). فلم يعد بالإمكان أن يحتشد الناس في الروايات الحديثة كما كانوا يجتمعون في إلياذة هوميروس وفي غابة روبن هود وفي صحراء الزير سالم ومواقع الظاهر بيبرس. فالرواية الحديثة (فردية) في حين يحتاج البشر - كائناً ما كان عصرهم وبلدهم - إلى التلذذ بحكاية الجماعات بما فيها من حشد إنساني يحبون أن يمارسوه هم في حياتهم اليومية. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الرواية يقرؤها القارئ وحده ويستمتع بها وحده ولا يشارك في التمتع بها أحداً غيره، أدركنا مدى الخسارة التي أوقعتها الرواية في البشرية.
لكن البشر الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الحكايات الجمعية القديمة وعن التجمع في أماكن عامة تمنحهم الإحساس الجماعي، وجدوا في استمرار المسرحية بديلاً كافياً عن كل ما جعلتهم الرواية القديمة والحديثة يخسرونه. فكانت (القصة) في المسرحية ملتقى جميع مشاعرهم الوجدانية والإنسانية.
2- الحكاية في المسرحية
لقد وقفنا هذه الوقفةَ الوجيزة عند الحكاية وتاريخها لنـُزيل أوهاماً فنية ضالَّة وهي أن (القصة) ليست شيئاً أساسياً في المسرحية، وأن القصة ليست إلا وسيلةً للموضوع ووعاءً للفكرة، وأن الاهتمام بها يحوِّل المسرحية إلى مجرد تسليةٍ سرعان ما تتحول إلى أحبولةٍ لإفساد ذوقِ المتفرجين، وأن هذا الاهتمام بها يساعد الجمهورَ البورجوازيَّ على هضم العشاء الدسم الذي تناوله قبل حضور المسرحية، وأن قوامَ التجديد في المسرح - وفي المنهج البريختي على الخصوص - يقوم على تحطيم تسلسل الحكاية مما يُفقِدها إمكانيةَ جعل المتفرج (يندمج) بها وينشغل بمتابعتها عن التفكير في مراميها، وأن ذلك كله يتناقض مع مهمة المسرح في التحريض على التغيير. وشيوعُ هذه الأوهام يعني أن الفكرة النبيلة التي كانت وراء تجديد بناء المسرح العربي في النصف الثاني من القرن العشرين وعلى امتداد الوطن العربي، خالطها ضلالٌ كبير في شأن (القصة في المسرح).
وقد سادت هذه الأغلوطةُ الفنيةُ النقدَ المسرحي منذ أواسط سبعينات القرن العشرين. وتبادلها المسرحيون يومذاك بكثير من التشدُّق ظناً منهم أنه الفهمُ الجديد لفن المسرح. وقد ساعدهم على التشبث بهذه الأغلوطة الذميمة أن المسرح البريختي يقوم فعلاً بتحطيم تسلسل الحكاية، وأن مسرحيات بريخت الأولى كانت ذات حكايات سقيمة. وأكَّد لهم هذا الضلالَ أن المسرح المتمرد على تقاليد الدراما كانت أكثرُ مسرحياته ذاتَ قصة ضعيفة، وأن بعضَ أنواع المسرح التسجيلي ومسرحَ الغضب ومسرحَ القسوة - وكلُّها انصبت في النقمة على ظلم الإنسان - لم تكن تهتم بتقديم قصة جميلة فكانت قصصها أقرب إلى أن تكون سقيمة. وأكد لهم هذا الاتجاهَ أيضاً أن مسرح العبث أو المسرحَ الطليعي أو المسرحَ المجدد الذي ينتمي إليهما يهجر القصة الجميلة، وأن قوته تقوم في الدرجة الأولى على أنه (لا شيء يحدث في المسرحية) أي أن المسرحية تخلو من القصة. ولعل مسرحيات بيكيت ويونسكو وآداموف كانت النموذجَ الأمثلَ على قوة بناء المسرحية دون الاعتماد على قصة قوية جميلة. وهكذا ارتبطت فكرةُ التجديد في البناء المسرحي بفكرة هجران القصص الجميلة. وبناءً على هذا الموقف العدائي من القصة في المسرحية هوجمت كثيرٌ من النصوص والعروض المسرحية العربية لا لشيء إلا لأنها كانت محكمةَ السرد القصصي ومحكمةَ التطوير في البناء الدرامي للقصة. وكوفئت كثيرٌ من النصوص والعروض المسرحية بجُزاف النقد المادح لأنها تركت الإحكامَ في بناء القصة المسرحية. وقد ترك ذلك أثراً على بعض الكتاب المسرحيين العرب في عقدي سبعينات وثمانينات القرن العشرين. ولكنه ترك أثراً مدمِّراً على كتاب تسعينات القرن نفسه. فإذا شفع لضعف القصة في بعض نصوص الفترة الأولى أن كُتّابها كان لهم غاياتٌ فكرية واجتماعية وسياسية تحريضية على التغيير وعلى مهاجمة الفساد والظلم هجوماً كاسحاً، فإن ضعفَ القصة في نصوص تسعينات القرن العشرين لا يشفع لـه موقفٌ فكري ولا نهجٌ سياسيٌ أو اجتماعي. فبدت شاحبةً لشحوب قصصها. وفقدت حلاوةَ السرد القصصي كما فقدت قوةَ الموقف الفكري. ومن هنا ندرك لماذا تبدو مسرحيات هذا العقد وما تلاه كأنها لا وجود لها. فلا خشباتُ المسارح تتلقفها، ولا صفحاتُ النقد تهتم بها. وعلى الكتاب المسرحيين العرب أن يحذروا الحذر كله من الجري وراء تلك الأكذوبة المسرحية التي أورثهم إياها الجيل الذي عاش في الفترة التي يسميها تاريخ النقد المسرحي العربي (فترة الازدهار العظيم). وقبل أن نأخذ في تفنيد هذه الأكذوبة وفي وضع القصة المسرحية موضعها الصحيح، أردُّ القارئ الكريم إلى نصوص الكتاب السوريين من أمثال سعد الله ونوس وممدوح عدوان ورياض عصمت وعلي عقلة عرسان ووليد إخلاصي ومصطفى الحلاج وغيرهم، وإلى مسرحيات نعمان عاشور ومحمود دياب وميخائيل رومان وألفريد فرج وغيرهم من كتاب مصر. وإذا استعاد القارئُ النصوصَ القويةَ لهؤلاء فسوف يجدها تقوم أول ما تقوم على قصةٍ قوية البناء محكمة السرد. وإذا أعمل هؤلاء الكتابُ في قصصهم قطعاً لسردها حيناً أولاً، وإذا شحنوها بالمواقف الفكرية والسياسية والاجتماعية حيناً ثانياً، وإذا زج هؤلاء الكتابُ دائرةَ اهتمام المتفرج في الجانب الفكري من مسرحياتهم دون دائرة الإمتاع القصصي حيناً ثالثاً، فقد كانوا ماكرين مكراً شديداً حين فعلوا ذلك كله من خلال قصص جميلة وحكايات فاتنة. وأسوق للقارئ - على سبيل التذكير والمثال - حكايةَ المملوك جابر الفاتنة وحكاية الملك الذي وضع غيرَه على عرشه في مسرحيتي سعد الله ونوس (رأس المملوك جابر - الملك هو الملك) وحكايةَ الرجل الذي حاكموه لأنه ترك سيفه في مسرحية ممدوح عدوان المتوترة (كيف تركت السيف)، وحكايةَ الكاتب الذي حاول إرضاءَ قيصر فما جنى إلا الغضبَ في رائعة علي عقلة عرسان (رضا قيصر)، وحكايةَ رياض عصمت المثيرة في (لعبة الحب والثورة) أو في (السندباد)، وحكايةَ درويش عز الدين المؤلمة في مسرحية مصطفى الحلاج (الدراويش يبحثون عن الحقيقة) أو حكايته العصماء في مسرحية (احتفال ليلي خاص لدريسدن). أي أن هؤلاء الذين احتلوا مكانة مرموقة في تاريخ الأدب المسرحي العربي كانوا ممن يسوقون القصص الجميلة المثيرة. ولو راجعتَ مسرحيات من سبق هؤلاء من أمثال مراد السباعي، لوجدت الفتنة كبيرةً في قصص مسرحياتهم. ولو استعرضتَ كبريات المسرحيات المصرية لبعض الكتاب الذين ذكرناهم، لوجدتَ فيها من قوة القصة وجمالها مثلَ ما وجدتَ في نصوص الكتاب السوريين.
إن ما تقدم يعني شيئاً جوهرياً في فن المسرحية هو أن القصة فيها مقصودةٌ لذاتها قبل أن تكون وسيلةً ومطيةً لأهدافها. وعلى الكاتب المسرحي المعاصر أن يعضَّ على هذه الفكرة بالنواجذ. وسبب ذلك لا يعود إلى ما تقدم ذكرُه من اهتمام الإنسان بالحكايات فحسب، بل يعود إلى سببين هما الأكثر جوهريةً وأصالةً. وهما:
آ- إن المسرحية هي الفن الوحيد الباقي من بين فنون القول الذي ما يزال يحتفظ بكل خصائص الفن الجمعي الذي يحتشدُ فيه الناس والذي ذكرنا أن البشر لا يستطيعون الاستغناء عنه. فهو يحقق للمتفرجين الالتقاءَ الحيَّ الذي يجعلهم يتلقون حكايته بحالة التوحُّد الوجداني. فيتشاركون في مشاهدته والاستماع إليه ثم يخرجون من قاعاته وهم يتبادلون الرأي حوله في لذة لا يقدمها لهم أي فن آخر. وقد تقول إن السينما والتلفزيون يقدمان قصصاً أمتع وأحلى وأبلغ في التأثير لما يملكان من وسائل خارقة في حشد المثيرات. وها هي الأفلام والمسلسلات التي تعرضها الشاشات الصغيرة والكبيرة اليوم قد بلغت مستوىً عالياً في تقديم الخارق من القصص والحكايات الواقعية والأسطورية والخيالية بحيث يمكن القول إن الشاشة في هذا العصر صارت ذهبية لماعة ولم تعد فضية فحسب. وهي بهذا الشكل تبدو أكثرَ قوة من المسرح ذي الوسائل المحدودة مهما بلغت صالاته من أدوات التقنية وتجهيزات الأخاديع والحِيَل. وقد يكون عرضٌ مسرحيٌ ما شديدَ الفقر فلا تزيد المرئيات فيه عن شجرة قميئة أو باب عتيق. فإذا قارن المتفرج بين ما تعرضه صالة السينما المجاورة لبيته أو التلفزيون القابع في بيته وبين ما يراه على المسرح، فسوف تبدو المقارنة في غير صالح المسرح. بل تبدو المقارنة نفسُها مضحكة لأن المقارنة يجب أن تتم بين شيئين متقاربين كالتلفزيون والسينما وليس بين شيئين متباعدين كالمسرح والسينما ووليدِها الأعورِ الدجال الذي هو التلفزيون. ومع ذلك، فإن المسرح يبدو، بوسائله البسيطة أقوى تأثيراً من فني السينما والمسرح لأنه يملك قوة لا يملكانها وهي أنه فن يشاهده (جمع إنساني متواصل) بكل ما يحفل به هذا الجمع من خصائص شرحناها. أما فن السينما، فمع أنه فن يُعرَضُ في صالاتٍ عامة ويحضره جمعٌ من الناس، فإنه يتحول إلى فن فردي بمجرد إطفاء الأضواء وبدء دوران الآلات. وليست العلاقة بين الفيلم وبين المتفرج إلا علاقةً بين صناعةٍ وبين مستخدمٍ لها. وأما التلفزيون فلا داعي لشرح علاقة مشاهده معه. فهو إنسان معزول حتى عن أفراد أسرته المتواجدين حوله. ولأن المسرح كذلك فإن لـه أساليبَه وأدواتِه النابعةَ من تركيب بنائه ومكان عرضه وطبيعة علاقته بالمشاهد. ومن المهم أن نذكر أن رجال المسرح أحسوا بالقلق والخوف حينما اكتُشِفت السينما وظنوا أنها ستقضي عليه. وحاول كثيرٌ منهم أن يستعير منها أدواتٍ يُدخِلُها إلى فن المسرح. ولكن الأمر لم يطُل بهؤلاء حتى أدركوا أن السينما لا يمكن أن تقضي على المسرح، وأن وسائلها المستعارة إليه كانت عبئاً عليه فهجروها وعادوا إلى وسائل المسرح القديمة ذاتها. وعندما طغى التلفزيون طغياناً كبيراً خاف المسرحيون - وما يزالون يخافون - من التلفزيون على المسرح أن يقضيَ عليه ويسرقَ منهم المتفرجين. وحاول الكثيرون منهم أن يستخدموا إبهارَ الصورة التلفزيونية. ومن هنا نشأ الإصرار على استخدام السينوغرافيا استخداماً واسعاً بحيث يصبح في كثير من الأحيان بديلاً عن مفردات العرض المسرحي كالنص والممثل. لكن الأيام تُثبت أن هذا اللهاث وراء تقليد الصورة التلفزيونية لم يكن أكثر من عبءٍ على المسرح. وبدأ المسرح - في العالم وفي الوطن العربي - يراجع دفاتره من جديد، ويقتنع بأن عليه أن يعود إلى أدواته الأساسية. وإذا كان المسرحيون يعودون إلى الأدوات الأصيلة للمسرح بكثير من الصعوبة والتردد، فإن ترددهم هذا يؤدي بهم إلى تأخير نهوض المسرح من جديدٍ بعد الانتكاس الذي عرفه في العالم وفي الوطن العربي منذ أواسط ثمانينات القرن العشرين. وعندما يتجرَّأ المسرحيون على العودة الصريحة الواضحة إلى أدوات المسرح الأصيلة، وهي النص والممثل، فسوف يجدون أن الجمهور يندفع إليهم بشوق ولهفة لأن الناس - كانوا وما يزالون - يسعَوْن سعياً حثيثاً نحو المسرح لأنه يحقق لهم، بأدواته ووسائله ذاتها، الالتقاءَ الجمعي الإنساني الذي لا يمكن لفن آخر أن يحققه. وسوف يكتشفون - وما أروع ما سيكتشفون - أن التلفزيون، وإن بدا خصماً لهم، فإنه ليس نِدّاً لفنهم. بل هو شيء آخر قد يأخذ من اهتمام الإنسان كثيراً من وقته ومن تفكيره. لكنه لن يكون بديلاً عن المسرح على الإطلاق. ولن يكون تأثيره كتأثير المسرح. ويا ليت المسرحيين يعجِّلون باكتشاف ذلك.
ب - إن المسرح هو الفن الأدبي الوحيد الذي يستطيع العودةَ إلى الملاحم والحكايات القديمة والأساطير والسير الشعبية القديمة التي ما يزال كلُّ شعب من شعوب الأرض يحنُّ إلى أجواء ما هو فيها من تراثه. فالرواية أصبحت عاجزة عن هذه العودة بعدما أصبحت (واقعية) تخترع شخصياتها وأحداثها من الواقع ففقدت القدرة على التحليق في أجواء الأساطير والبطولات الجمعية وفي غرابة الأحداث والوقائع. ودليل ذلك أن الرواية عندما ضاقت بواقعيتها منذ بداية القرن العشرين وأدركت مدى جفافها عندما ابتعدت عن منابع الحكايات القديمة، حاولت أن تكسر هذه الواقعية بالخروج إلى ما يخلخل الواقعية دون أن تستطيع الفكاك منها. ومن هذه الخلخلة نشأت أنواعٌ من الرواية كالسريالية والنفسية والاستبطانية والخارجة عن النسق المنطقي لترتيب الأحداث وإلى غير ذلك مما يمكن الرجوع إليه في الكتب التي تؤرخ للرواية الحديثة، دون أن تستطيع العودة إلى خلق الأجواء القديمة. أما المسرح فهو ما يزال يملك القدرة الكاملة على العودة إلى الحكايات القديمة وإلى أجواء الأساطير والسير الشعبية والحكايات الغريبة التي تحفِلُ بأبطالٍ أسطوريين يندّون عن الاندراج في بوتقة الواقع بمقدار ما يغوصون في النفس الإنسانية في مختلف منازعها. ودليل ذلك أن الملاحم والأساطير الأوروبية ماتزال منبعاً لكثير من المسرحيات. ودليل ذلك أيضاً ذلك الكمُّ الكبير من المسرحيات العربية التي أحيت الأساطير العربية وحكايات ألف ليلة وليلة كما أحيت سيرة عنترة وملحمة الزير سالم وغير ذلك من أجواء الأساطير. والمسرح يفعل ذلك ببساطة مدهشة. ويستطيع أن يقدم إلى متفرجه هذه الحكايات القديمة بالحيوية ذاتها التي كانت تتحقق لها في مجالس السمر القديمة. وتخلق لدى المتفرجين تلك اللذة الفائقة التي كان المستمعون يشعرون بها. ومن هنا نستطيع إعادة النظر في نشأة وتطور المسرح في العالم. فإذا كان الشكل الذي نسير عليه اليوم هو النسق الأوروبي الأرسطي الذي وضع المسرح اليوناني قواعدَه، فإن لكل شعب من شعوب الأرض أشكالَه المسرحية التي أخذ اليوم يعود إليها. ففي مصر القديمة وُجِدَ شكلٌ مسرحيٌ يقول كثير من المؤرخين إنه أستاذ المسرح اليوناني. ولشعوب شرق آسيا أشكالٌ مسرحية قديمة ماتزال موجودة في مسرحهم اليوم. وقد حاول كثير من النقاد العرب أن يجد في مجالس السمر العربية وفي احتفالاتها الدينية وغير الدينية أشكالاً بدائية من المسرح. وسببُ وجود هذه الأشكال أن رواة الحكايات القديمة كانوا يحاولون روايتها بكثير من الإثارة. وهذه الإثارة تتحقق في إبداع روايتها ببراعة المتكلم الراوي، أو بمحاولة تشخيص أحداث الحكايات. وهذا يعني أن تشخيص هذه الحكايات قديمٌ قِدَمَ الحكايات نفسها. وما يزال المسرح قادراً على إحيائها وتقديمها بوسائله البسيطة تلك التي أشرنا إليها.
إن هذا يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء أن (القصة) في المسرحية عنصر أساسي وأصيل. وعلى الكاتب المسرحي إذا أراد أن يكون ناجحاً، أن يبذل كل العناية في تقديم القصة الجميلة الفاتنة. ويعني أيضاً أن على كتّاب المسرح العربي الذين بدؤوا يدرجون على ساحة المسرح في تسعينات القرن العشرين، أن يرجعوا عن الضلالة في التقليل من شأن القصة. وأن يرفضوا رفضاً باتاً وجازماً تلك الأكذوبة الأغلوطة التي ورثوها عن الجيل الذي سبقهم بأن القصة ليس لها كبير أهمية في المسرح. فبهذا الرجوع عن الضلال يمكن لهم أن يتقنوا فن كتابة المسرح.
3-تعريف بالحبكة وتحذير
الحبكة في المسرحية هي التي تحول لذائذ الحكاية إلى (قصة مسرحية). فهي التي تشبك وقائع الحكاية في تعارض عنيف بين رغبات الشخصيات. وتعريفها الذي هو جوهرها هو (أن تترابط أحداثُ القصة بتسلسل منطقي). أي أنه حدث كذا ولذلك حدث كذا. أما القصة في الرواية فتأتي بتسلسل زمني. أي أنه حدث كذا ثم حدث كذا. وهذا التسلسل المنطقي هو الذي يخلق التشويق لأنه هو الذي يصل بالحكاية إلى منطقة حرجة تتأزم فيها أحوال الشخصيات ويبلغ الصراع ذروته التي يسأل فيها المتفرج نفسه: ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وهذا السؤال المدهش: (ماذا سيحدث بعد ذلك) لقي هجوماً عنيفاً من النقاد الجامدي القلب. فقد اعتبروه مؤدياً إلى التعلق الزائد بالحكاية يصرف المتفرج عن مراميها. وما علموا أن هذا السؤال هو اللهفة الإنسانية للحكايات. وهو الذي يجعل الناس يتلهفون لرؤية المسرحيات كما كانوا يتلهفون للالتفاف حول الراوي أو الحكواتي. وهؤلاء النقاد الجامدو القلوب يعاملون المسرحية كما يعاملون قطعة نفيسة يُخشى عليها الكسر إن تزاحم الناس عليها أو إن لم تكن درساً في الغوص على نفسية الشخصيات تحليلاً وتدقيقاً. وحجتهم في ذلك أن الحبكة المتقنة الصنع بلغت ذروتها مع الكاتب الفرنسي (سكريب) الذي حوَّل المسرحية إلى نوع من الرواية البوليسية فنسيه تاريخ المسرح. وهذا صحيح. لكن الحبكة المتقنة الصنع استلمها العملاق النرويجي إبسن فامتلك ناصيتها وملأها بالفكر والتحليل والمعالجات الإنسانية، فقفز بفن الدراما قفزة كبيرة خلَّصتها من كثير من شوائبها. وإذا أردنا أن تعود للمسرح نكهتُه وتلهف الناس عليه، فقد وجب علينا أن نعود إلى ذلك السؤال المدهش: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ومفتاح هذا السؤال هو الحبكة.
وتتألف الحبكة من مراحل ثلاث هي: (التمهيد - الوسط - النهاية). ففي التمهيد يقدم الكاتب شخصياته ويرمي الخيوط الأولى للحكاية. وفي الوسط يزج الشخصياتِ في لحظة تأزم الصراع. وهنا تأتي العقدة أو أزمة المسرحية التي يمسك فيها الكاتب بأنفاس المتفرج ويجعله يتساءل بلهفة: ماذا سيحدث بعد ذلك؟. وفي النهاية تنحلُّ الأزمات وينتهي الصراع وتُختَتم الحكاية.
إن هذا التنسيق للحبكة بمراحلها الثلاث هي الصيغة التي وصلت إليها المسرحية في القرن التاسع عشر بعد طول تجوال على خشبات المسارح عبر القرون وعلى امتداد البلدان. وهي التي يصفها النقاد بأنها (البناء التقليدي للمسرحية). وهي التي ركبتها الواقعية. وهي التي تمرد عليها المؤلفون منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن العشرين. وهي التي استمات المؤلفون العرب حتى يتقنوها منذ أوائل تعرفهم على المسرح حتى أواسط القرن العشرين. وهي التي حاولوا التمرد عليها منذ منتصف ذلك القرن. فخلقوا
- بتقليدها وبمحاولات الخروج عليها - فترة الازدهار في مسرحهم.
ورغم أن تاريخ المسرح عرف محاولات التمرد على تسلسل وترابط عناصر الحبكة، فإنها كانت أكبر من كل محاولات الخروج عليها. فهي القبضة الحديدية التي تمسك بخناق كل مسرحية شاء الكاتب أم أبى لأنها الشكل الوحيد الذي لا بد أن تسير عليه المسرحية. وكل محاولات الخروج عليها كانت عبارة عن تعديل لأركانها أو تقديماً وتأخيراً لهذه الأركان، أو كانت قطعاً لتسلسلها المتلاحم. حتى المسرحيات التي لا حكاية فيها لأنه لا شيء يحدث، لم تستطع الخروج عن قبضة الحبكة الحديدية. فهي مبنية بإحكام التتابع المنطقي للأحداث. فإذا خلت من مراحلها الثلاث: البداية والوسط والنهاية بهذا الوضوح الجلي، فقد كان لها بداية لا شيء يحدث فيها. ووسط لا شيء يحدث فيه. ونهاية لا شيء يحدث فيها.
وإذا كان المؤلفون العرب قد ادَّعوا الانفلاتَ من سيطرة الحبكة فقد كانوا كاذبين في دعواهم. فإن المسرحيات الكبيرة التي كتبوها كانت ذات حبكة محكمة التسلسل بذلك الرباط المنطقي الصارم.
ولا أريد الدخول في تفصيل مراحل الحبكة الثلاث: البداية والوسط والنهاية. لكني أريد الوقوف عند (البداية) التي تسمى التمهيد. فهي أصعب أركانها ومقتل جمالها وخاصة حين انتشرت الواقعية. ففي الواقعية لا بد أن تقوم الشخصيات في المسرحية بأفعال موازية لأفعالها في الحياة. فحين يدخل الرجل بيته، يقوم بخلع حذائه ومعطفه. ويلبس الحذاء واللباس المنـزليين. وينادي زوجته أو ابنته. ولا بد أن ترحب به الزوجة أو الابنة المستقبلة. ولا بد أن تسأله عن شؤون النهار وعن سعيه فيه. ولا بد أن يستتبع ذلك رداً من الرجل. ولا بد أن يكون هذا الرد متضمناً انزعاجاً أو سروراً. وقد يسوقهما الحديث إلى الكلام عن شخص آخر وآخر.
صحيح أن هذا الحديث هو المفتاح الأول للتعرف على الشخصيات وأطراف المشكلة التي ستبنى عليها الشخصيات والحكاية، لكن الواقعية التي طالبت بأن يكون الفعل المسرحي شبيهاً بأفعال الحياة، أوقعت التمهيد في الإطالة. والإطالة تهدد المسرحية بالوقوع في الملل. وهذه الإطالة هي الدودة السامة التي نخرت في ركن التمهيد في المسرحية الواقعية وفي الأنواع التي تلتها لأن كتابها يرغبون أن يماثلوا أفعالَ الحياة على عكس ما فعله كتاب الكلاسيكية والرومنسية. والمثال على ذلك - كما يقول أحد النقاد الظرفاء - أنه لا يكاد المتفرج يجلس على مقعده حتى يكون (الملك لير) قد وزع ملكه على بناته، في حين يحتاج الكاتب الواقعي أو المعاصر إلى زمن طويل يتثاءب فيه المتفرج حتى يكون الملك لير قد فعل ذلك.
ولو سألنا عن مصدر هذا التطويل للتمهيد لوجدناه عند ستانسلافسكي الذي وضع أسس الإخراج المسرحي بعد أن استمدها من الواقعية ثم رسَّخها وقيَّد الناس بها. وإليكم الدليل.
في الدرس الذي يلقيه ستانسلافسكي على طالبَيْه حول الدخول إلى مسرحية (عطيل)، ينتهي إلى إلقاء التعليمات التالية:
(ادخلا وانظرا حولكما للتأكد من عدم وجود أحد يراقبكما أو يسترق السمع. بعد ذلك أحيطا بنظركما جميعَ نوافذ القصر. ترى؟ هل يتسرب منها النور؟ هل يمكن من خلالها رؤية أحد من سكان البيت؟ فإذا خُيِّل إليكما أن ثمة أحداً يقف وراءها، فحاولا أن تجتذبا انتباهه إليكما. من أجل ذلك لا يكفي أن نصرخ. بل يجب أن نتحرك أيضاً ونلوح بأيدينا. قوما بمثل هذا الكشف والتحقق في أماكن مختلفة وذلك بالتوجه إلى نوافذ مختلفة. ابلُغا في تنفيذ هذه الأفعال حداً من البساطة والطبيعية الحياتية يدفعكما إلى الإحساس بالصدق والإيمان بهذا الصدق فيزيولوجياً. وعندما تتأكدان بعد عدد من المحاولات أنه ما من أحد يسمعكما، فكِّرا بإجراءات أكثر فعالية وأقوى حسماً. اجمَعا عدداً كبيراً من الحصى الصغيرة واقذفا النوافذ به. طبعاً لن تصيبا الهدف دائماً. ولكن عندما تنجحان في ذلك، راقبا بإمعان لترصُّدِ ظهور أحدٍ ما من سكان البيت. إن إيقاظ أحدهم يكفي لإيقاظ الآخرين. هذه المناورة لن تنجح معكما على الفور. وستضطران لتكرارها بالتوجه إلى نوافذ أخرى. أما إذا لم تُجْدِ محاولتُكما هذه أيضاً، فابحثا عن وسائل وأفعال أقوى. حاولا تقوية الضجة والطرْقِ لتعزيز الصراخ والصوت. من أجل ذلك يجب استخدام الأيدي والتصفيق بالأكف. اخبطا بقدميكما على بلاط المدخل...)([5])
في هذا النص - وهو أسلوب فني في العمل المسرحي - يستغرق مشهد إيقاظ أهل ديدمونة لإخبارهم بزواج ابنتهم من عطيل مدة لا تقل عن عشر دقائق إن لم يكن أكثر. وهذه المدة للتمهيد إلى الحدث الرئيسي جميلة لأنها تشوق المتفرج لما سيحدث بعد ذلك. فهي تبشر بالحدث الخطير التي وقع إذ تزوج المغربيُّ العبدُ السابق من سيدة نبيلة الأرومة وما أفظع ذلك. ولا شك أن منهج ستانسلافسكي في التمثيل غزا العالم كله وترك آثاراً خيِّرةً على العالم كله. وقد استمده من مذهب الواقعية التي أرادت أن تتسم بصفة (الطبيعية والحياتية)، والتي كان إبسن وتشيخوف قد أرسيا دعائمها. ثم تلقفها الكتاب المسرحيون في العالم حتى صارت أسلوباً مكيناً في التأليف المسرحي. وكانت هذه الطبيعية الحياتية ممكنة فيما سبق الهزيع الأخير من القرن العشرين حين كان العرض المسرحي يستغرق ساعتين أو ثلاثاً. لكنها اليوم صارت أسلوباً مُهلِكاً للكتابة التي ستتحول إلى عرض مسرحي. وإذا كان على الصراع أن يمضي سريعاً حاداً كأنه الشهاب الناري، فإن الوصول إلى ذروته يجب أن لا يتمطط في التمهيد الذي كان سمة كتاب الواقعية. وليتذكر القارئ الكريم النصوص الواقعية منذ إبسن حتى آرثر ميللر وتنيسي ويليامز، وسوف يجد هذه النصوص يستغرق التمهيدُ فيها مدة طويلة كان من سَبَقَ الواقعيةَ يتجنبها. وليتذكر القارئ الكريم أيضاً النصوص العربية الشامخة، وسوف يجدها تطيل مدة التمهيد لتخلق المناخ المناسب لاندفاع الحكاية نحو الذروة واحتدام الصراع.
لكن كاتب اليوم لا يملك إلا زمناً قصيراً ينجز فيه حكايته بتمهيدها وعقدتها وانحلال صراعها. ولن يستطيع ذلك إذا اضطر إلى تقديم التمهيد في مدة لا تقل عن عشر دقائق. وسبيله إلى ذلك أن يكون التمهيد سريعاً قصيراً لا يتقيد بتفاصيل الحياة كاملة، بل يوحي بها بسرعة حتى ينتقل إلى الحدث الرئيسي.
فليحذر الكاتب من الوقوع في فخ هذه الواقعية الدقيقة. ولتنكسر أصابعُ الناقد وأقلامُه إن دفع الكتّابَ إليها. فإن نجا منها الكاتب أمكنه أن يدخل إلى حرارة الحكاية بسرعة. ويساعد صراعَه على التحلي بالصفات والخصائص التي ذكرناها. وليعلم الكاتب والناقد أن الواقعية لا تعني (نقل الواقع) بل الإيحاءَ به. فيكفي أن يدخل ذاك الرجل بيته وأن ينادي امرأته أو أخته ويدخل بها في صلب الحكاية بأسرع وقت ممكن. وسوف يكون القارئ أو المتفرج مسروراً بهذا الدخول السريع. فهو يجنِّبه المللَ والتثاؤب.
خصائص القصة المسرحية وعلاقتها بالحبكة
إذا كان للقصة في المسرحية كل هذه الأهمية، فإن ثمة خصائص تحقق لها هذه الأهمية التي وصفناها لها، وثمة كيفيةٌ تتحقق بها فعاليةُ هذه الأهمية في البناء المسرحي. وبعبارة أخرى، ثمة جماليات للقصة عند تحولها إلى حبكة درامية.
والقصة في المسرحية لا تكون جيدةً إلا إذا كانت جميلةً تُثير لدى المتفرج الترقُّبَ والتوجس ولذةَ المتابعة، وأن تمتلئ بالحيوية والحرارة، وأن تكون مشحونةً بالصراع الذي يحبس الأنفاس. وهذه القصة الجيدة الجميلة هي التي تتقطَّعُ أعناق الكتاب للوصول إليها. وهي التي لا يمكن الوصول إليها إلا إذا امتازت بخصائص لا بد من الاتِّصاف بها رغم أنف جميع المحاولات النقدية التي حاولت تقليلَ أهميتها، وهي التي لا بد من عودة كتابنا المسرحيين إليها إذا أرادوا أن يثبتوا قدمهم في ميدان التأليف المسرحي، وهي التي أدى الافتقارُ إليها إلى هبوط كثيٍر من نصوصنا المسرحية.
أول هذه الخصائص أن تكون غريبةً مثيرةً تقرُب من حالة الاستثناء عن القاعدة مما يخلق حالةَ الدهشة والتوفز ولذةَ المتابعة عند المتفرج. ولو راجعنا كبريات المسرحيات في تاريخ العالم لوجدناها قصصاً نادرةَ الحدوث في الواقع. فليس كلُّ واحد يقتل أباه ويتزوج أمه. وقليلاً ما يقف أحد الأخوين في صفٍّ ويقف الأخ الثاني في صفٍّ مضادٍّ لـه ويتحاربان ويقتلان بعضهما. ومن النادر أن نجد في تاريخ العروش والملوك من يوزع مُلْكَه بين بناته الثلاث وهو على قيد الحياة. ونادراً ما نجد شاعراً طويل الأنف يعشق فتاة جميلة فلا يبوح لها بحبه لأنها تحب شاباً وسيماً. وإذا به يكتب القصائد الغرامية ويعطيها لغريمه الوسيم حتى يتقرب إليها.
أتقول إن هذه الغرائب مقتصرة على المسرحيات التي استمدَّت قصتَها من الأساطير وحكايات التاريخ؟ تعال إذن إلى المسرحيات التي استمدَّت قصتَها من وقائع الحياة اليومية. وسوف تجد أن كبرياتها قامت أيضاً على غرائب القصص. فليس كلُّ طبيب في إحدى المدن يكتشف جرثومةً في مياه الشرب ويكون أخوه رئيسَ بلدية تلك المدينة ومستفيداً من مشروعٍ على المياه نفسها. وإذا بالأخ الثاني ينهش لحمَ أخيه حياً حتى يورده موارد الهلاك كما في مسرحية إبسن (عدو الشعب). وليس كلُّ زوج يدفع زوجته إلى حضن رجل آخر لكي يصون شرفَها كما فعل أوستروفسكي في (لكل عالم هفوة). وليس من العادي أن يجتمع في أحد الأقبية أكثرُ من عشرة أشخاص بينهم اللص والنبيل السابق والشحاذ والطالب والحذّاء كما فعل غوركي في (الحضيض).
ولا شكَّ أن كتاب العصر الحديث يجدون صعوبةً كبيرة في شحن مسرحياتهم بالغريب الشاذِّ من الأحداث والوقائع لأن موضوعاتهم مأخوذةٌ من الحياة اليومية العادية التي هي المصدرُ الوحيد لمادة قصصهم. وإذا كانت الأساطير والملاحم والحكايات القديمة تعطي الغرابةَ مما يسهِّل على الكاتب تحقيقَ هذه الخصيصة، فإن الحياة اليومية العادية تتأبّى على هذه الغرابة. ومن هنا ندرك نقطة هامة هي أن كتاب المسرح منذ اتجاهه نحو الواقعية كانوا أمهر في صناعة المسرح ممن سبقهم حين استطاعوا أن يستخلصوا الغريبَ من العادي. ومن هنا أيضاً نقف عند نقطة تأثَّر بها أجيالُ الكتاب المسرحيين العرب المحدَثين فأصابهم التأذّي دون أن يكون لهم كبيرُ ذنبٍ في هذا التأثر المؤذي. وهذه النقطة هي ترجمةُ الكثير من المسرحيات الواقعية ذات القصة العادية غير الغريبة إلى العربية تحت اسم (المسرح العالمي). فهذه التسمية توحي بأن هذه المسرحيات تحتلُّ مكانة رفيعةً في تاريخ المسرح. والحقيقة أنها مسرحيات عادية لا تصلح مقياساً للمسرحية الجيدة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان. وقد أدّى احترامُها إلى الاعتقاد أن القصة العادية تصلح مادة للمسرحية. فنتج عن ذلك كثيرٌ من المسرحيات العربية التي لا تحتفظ بقيمة كبيرة لسبب بسيط جداً وبليغ جداً هو أنها اعتمدت قصصاً عادية ليس فيها (الغرابة) التي هي جوهر القصة المسرحية.
ويستطيع الكاتب أن يأتي بغرائب القصص من الحياة اليومية العادية حين يأتي من الحياة المعاصرة بالنادر من وقائعها. ولن يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا أدرك أن (محاكاة الواقع) التي هي الأصل في المسرحيات الواقعية ليست ما (وقع فعلاً) بل هي (ما يمكن أن يقع). فبهذا المفتاح السحري يفتح الكتاب المسرحيون مغاليق الغرائب من الأحداث ويدفعون قصص مسرحياتهم إلى نقطة الدهشة التي تمتاز بها المسرحيات ذات القصة التاريخية أو الأسطورية.
ثاني هذه الخصائص أن يكثر في المسرحية (الفعل) وأن يترافق باستمرار مع (الحوار). والمسرحيات الناجحة هي التي تعجُّ بالنشاط حتى كأنها خلية نحل. فإذا كثر الجدلُ والنقاشُ وقلَّ الفعل، انصرف المتفرجُ عن المسرحية لأنه لم يأتِ لسماع محاضرة فكرية مهما كانت مهمة. وإذا كثُرَ الفعلُ وقلَّ الحوار فقد يستطيع العرضُ المسرحي أن يشدَّ انتباهَ المتفرج، لكنه يكون قد خرج به من عرض مسرحي إلى نوع من السيرك أو الأكروبات. ولن يكون مثلُ هذا النص قادراً على الوقوف بنفسه قوياً لأنه هجر أحدَ أهم أركان المسرحية وهو الحوار الجيد الجميل. ولنتذكّر دائماً أن المسرحية في نهاية الأمر نوعٌ من الأدب الذي تقوم فيه اللغة بصوغ الحكاية وتحديد مسار القصة. ولنأخذ مثالاً على ذلك مسرحية (هملت) العاجز عن الفعل لأنه متردد، والذي يمضي في المسرحية كثيرَ الثرثرة. ولا يقل أصدقاؤه عنه ثرثرةً تكاد في نهاية الأمر أن تجعل المسرحية حواراً محضاً. لكن هذه الثرثرة الكثيرة تترافق بعدد كبير من الأفعال الكبيرة. فهو يلاحق شبح أبيه. ويقوم بالتحقيق على طريقة القصة البوليسية ليتأكد من أن عمه قتل أباه. ويعيد تمثيل الجريمة فيوغل في القصة البوليسية على طريقة تمثيل الجريمة. ويصطنع الجنون فيتيح لـه ذلك أن يأتي بأفعال كثيرة تحول المسرحية إلى خلية نحل. ويتمادى في الأفعال حتى يقتل أحد الوزراء وحتى تنتحر حبيبته. ثم يبارز خصمه ويموت قتلاً معه.
وقد افتُتِنَ أغلبُ كتاب المسرح العربي منذ بداية تسعينات القرن العشرين بـ (الفعل) افتتاناً شديداً. ومع أنهم يقدمون نصاً مسرحياً قائماً على الحوار، فإن هذا النص أقرب إلى السيناريو منه إلى الحوار المسرحي. ولعل انجرافَهم وراء لعبة التلفزيون الخادعة وجريَهم وراء (الصورة) هو الذي حوَّل الكتابة عندهم من (نص مسرحي) إلى (سيناريو مسرحي). فخرجوا من حومة المسرح مأسوفاً عليهم لأنهم ضيَّعوا موهبتهم حين تجاهلوا العناصر الأبدية لفن كتابة المسرح. والطريف في الأمر أن الفئة المسيطرة من هؤلاء الكتاب هم مخرجون تحولوا إلى كتاب. ولذلك تجد الإعلانات عن العروض المسرحية أنى ذهبتَ في أرجاء الوطن العربي على الشكل التالي: (نص وإخراج فلان). وحين حوَّلوا النص المسرحي إلى سيناريو يخدم رؤيتهم الإخراجية ساروا في طريق (تطويع النص للعرض). وهذه الطريق تناقض تاريخ المسرح كله. وما أشد التباينَ بين كتاب هذا العقد وما تلاه، وبين كتاب الفترة التي سبقته. فقد كان الإخراج يقصد إلى إبراز عناصر القوة في النص المسرحي. ولنتذكر أن الكتاب الذين كانوا مخرجين في عقود ستينات وسبعينات وثمانينات القرن العشرين كانوا قلة في كل أرجاء الوطن العربي. وكثيراً ما كان التعامل بين المخرج والمؤلف يتم من خلال (تحسين النص المسرحي) لإبرازه مادةً أساسية في العرض المسرحي. ولنا في التعاون بين فواز الساجر وسعد الله ونوس وبين ممدوح عدوان ومحمود خضور خيرُ نموذجٍ على تحسين النص المسرحي وإلغاءِ ما هو زائد فيه باعتباره نصاً مسرحياً لا باعتباره مادة كلامية لعرض مسرحي. وهنا لا بد من أن نهتف بكتابنا المسرحيين بأعلى صوت: (احذروا من أسلوبكم المريض. وكونوا كتاباً لا تهتمون بالإخراج. فإذا أردتم أن تُخرِجوا نصوصكم بعد ذلك فاحرصوا على تحسين نصوصكم المسرحية من خلال إحياء القصة المسرحية على خشبة المسرح. فبتقديم الحكاية المدهشة فحسب، تكتبون نصوصاً مسرحية).
ثالث هذه الخصائص أن تكون الأفعال والأقوال في بناء القصة مرتكزةً إلى الأسباب النفسية بحيث يبدو الكلام والفعل ضرورةً لا بد منها. فقتلُ الرجل لأبيه أو خيانتُه لوطنه أو هجرُه لحبيبته أفعالٌ لا بد أن يسبقها كشفٌ نفسي بالحوار حتى تأتي منطقيةً معقولة مقبولة مهما بدا من شذوذها في الحياة الواقعية.
وعندما يهتم الكاتب بالأسباب النفسية لحوار وأفعال الشخصيات، فإنه يدفعها - غصباً عنها - إلى التغير والتطور. ويمنح المسرحيةَ حلاوة وتشويقاً هما السببان اللذان من أجلهما يذهب المتفرج إلى المسرح. فإذا لم يحدث هذا التغير والتطور بدت المسرحية راكدةً في بركة آسنة من الدوران في المكان. وهذا التطوير والتغيير هو الذي يخلق ما يسمى في بناء المسرحية (التصاعد الدرامي). ويقوم هذا التصاعد على ركنٍ ركينٍ في الأفعال والأقوال هو شحذُ وصقلُ وتحديدُ الفعل وردِّ الفعل. وهو ما يسمى في مصطلحات النقد المسرحي (سجلَّ الضغط والاستجابة).
إن دفع القصة في هذه السبيل الوحيدة الصارمة هي التي تحوِّل الحدثَ الغريب الذي يجب أن تقوم عليه المسرحية من مجرد قصة إلى (قصة مسرحية). وهي التي تعود بالمسرحية إلى منابعها الأولى وتحفظ لها أخصَّ خصائصها وهي أنها الشكل الأدبي الوحيد الباقي من مجالس السمر القديمة وأماكن الاحتفالات العامة. وعلى الكتاب المسرحيين أن يدركوا بكل عمق وإصرار أنهم ورثة الرواة والحكواتية القدامى، وأنه مطلوبٌ منهم في عصر التكنولوجيا والسينما والتلفزيون أن يحافظوا - مستعينين بوسائل التكنولوجيا - على صفتهم القديمة هذه. وهاهو العالم كلُّه أمامنا يؤكد هذه المهمة لكتاب المسرح والعاملين فيه. فقد اخترع العالم في عقد تسعينات القرن العشرين (المسرح التجريبي) الذي هجر هذا الدورَ الافتتاني لقصص المسرح، وتخلى عن تقديم المدهش المثير من الحكايات. واستخدم بديلاً عنها تقنيات التكنولوجيا ظناً منه أن المتفرج يندهش بها. وإذا به ينهزم أمام المتفرجين هزيمة نكراء. وإذا به - بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على ولادته - يعجز في جميع أنحاء العالم وفي وطننا العربي عن تقديم نص مسرحي واحد قوي. فكان الموجةَ المسرحيةَ الوحيدة في تاريخ المسرح التي ليس لها نصوص قوية. ولأنه دون نصوص، فإنه دون ملامح. ولأنه دون ملامح، فإن عروضه متشابهة أنى قُدِّمت. ولأنها متشابهة، فقد فقدت خصوصيتَها التي يتقدم بها كلُّ عرضٍ مسرحي إلى أبناء قومه فيفتنهم ويدهشهم. ولأنها دون خصوصية، فإنها لم تترك آثارَها الفكرية على المتفرجين. ولأنها لم تترك هذه الآثار، فإنها تبدو معلقة في الفراغ. ولأنها معلقة في الفراغ، فإنها ستبقى في الفراغ دون أن تدخل سياق التاريخ الأدبي والإنساني والفني للبشرية.
إن هذه الخصائص الثلاث للقصة المسرحية والتي تجعلها ذات تأثير وحيوية وجمال، لا قيمة لها إذا لم توضع في بناء محكم متسلسل يسميه نقاد المسرح (الحبكة المسرحية). ولا أريد الحديث عن صناعة الحبكة فهي معروضةٌ بوفرةٍ في كتب النقد المسرحي. ولكني ألخِّصها بأنها هي التي تضع جميعَ عناصر الحكاية من الشخصيات والحوار والأفعال ضمن طرفي الصراع المسرحي الذي لا يكون المسرحُ مسرحاً إلا به. ولن تُحقِّقَ الحبكةُ وضعَ الصراع في طريق التصاعد إلا إذا كانت متقنةً شديدةَ الإتقان. ولن تكون متقنةً إلا إذا حذف الكاتب كلَّ فعل أو قول يؤخر تصاعد الصراع المسرحي وكلَّ فعل أو قول لا يزيد شخصياته إيضاحاً وتوتراً.
ولا يظنَّنَ أحد أن الحبكة بهذا الشكل هي الحبكة التقليدية. وآهِ ثم آهِ من الرأي النقدي الشديد الخطأ الذي حرَّم على كتابنا المسرحيين اعتناءَهم بالحبكة بحجة أنها تقليدية. فهي أساس المسرح الذي لا يستطيعه إلا يدٌ صارمةٌ صَناعٌ أدركت خصائصَ المسرح وطبيعةَ وجوده كما أدركت خصائص القصة المسرحية التي نؤكد مرة بعد مرة أنها الشكل الوحيد الباقي من الاحتفاليات الجمعية التي تُروى فيها الحكايات. فليرجِعْ كتابُنا إلى إتقان الحبكة. وليعلموا أنها صديقهم المحبُّ وليست عدوَّهم كما أقنعتهم الكتابات النقدية السقيمة التي تتجاهل ماهية المسرح وتتجاهل تاريخه ولا تهتم بجمهوره. وليعلموا أن جميع التيارات التجديدية التي حطمت المسرح التقليدي الأرسطي قامت على تقسيم مراحل الحبكة ولم تقم أبداً على تقطيع أوصالها، وقامت على حبكات قوية صارمة لم تخرج أبداً عن صفاتها. وكل ما فعلته أنها وضعتها في سياق جديد كان أشدَّ إتقاناً لها. أتريدون الدليل على ذلك؟ ارجعوا إذن إلى نصوص بريخت القوية مثل (الأم شجاعة) أو (غاليلو غاليلي). فسوف تجدون فيهما حبكةً قوية متينة هي من أبرز حبكات المسرحية في تاريخها الطويل. وارجعوا إلى مسرحية (انتظار غودوت) التي يعتبر النقاد أنها النموذج الأمثل لا لهجران القصة المثيرة فحسب، بل ولهجران الحبكة المتقنة أيضاً، ويضعونها في رأس قائمة (المسرح الثوري) الذي انصبَّت ثوريتُه على النهج الأرسطي أي التقليدي. وسوف تكتشفون أن هذه المسرحية تقوم على قصة مدهشة غريبة فاتنة هي قصة رجلين ينتظران وهماً لا يأتي. والغرابة هنا تكمن في حكاية الانتظار المتلهف الذي يجعلك تقول كل لحظة: الآن سيأتي المنتظَر فإذا به لا يأتي. وإذا ضرب الكاتبُ الحبكةَ التقليدية بأنه لا شيء يحدث في المسرحية، فإن هذا الشيء الذي لا يحدث موضوعٌ في سياق حبكة صارمة غايتُها أن تؤكد باستمرار أنه لن يحدث شيء. ولأن كثيراً من الكتاب لم ينتبهوا إلى غرابة القصة المثيرة وإلى الإتقان الشديد للحبكة، فقد فشلت جميع النصوص التي حاولت السير على نهجها لأنها خلت من غرابة القصة وإتقان الحبكة.
إنني لا أدعو الكتاب إلى العودة إلى البناء التقليدي للمسرحية. لكني أقول لهم: إن السبيل الوحيد للعودة إلى كتابة النص القوي هو ركوب متن الحبكة القوية المحكمة البناء. فإن أتقنه الكاتب فقد امتلك صناعة المسرح. وهي التي أثبت تاريخ المسرح أنها جوهره وسرُّ قوته. وبكلمة موجزة: إنها صديق الكاتب وحبيبته الوفية.
- 2 -
الصراع المسرحي..
براعة فنية ورؤية اجتماعية
تمهيد في معنى الصراع المسرحي
يكون الشارعُ في الحي الهادئ ساكناً وقد انصرف الناس فيه إلى شؤونهم لا يلفت انتباهَهم عنها شيء. وفجأة ينبثق من زاوية بعيدة فيه شجارٌ بين شخصين. وإذا بالمنشغلين يتركون ما في أيديهم ويراقبون المشاجرة بلذة خفية مادامت لا ضرر فيها. فإذا برزت السكاكين هجم بعض الشجعان لفضِّ النـزاع. فإذا جُرِّدت المسدسات قلَّ عدد الشجعان المبادرين إلى التدخل. فإذا انطلق الرصاص بادر المشاهدون إلى الهرب. فإذا وقعت الجريمة صارت مادة حديث لأهل الحي يتبادلونه بمزيج من الإثارة والتشوق واللهفة. فإذا جاءت الشرطة صارت المادة المروية أغنى في نقل الخبر وفي المتعة المرافقة لـه. وسرعان ما يتأوّل الناسُ أسباباً للشجار وما أدى إليه. وكلما كانت الأسباب ضخمة كانت أشد إثارة. فالشتيمة أقلُّ إقناعاً بالجريمة من محاولة التحرش بالزوجة أو البنت أو الأخت. والتحرش بواحدة منهن تخلق عند الناقلين للخبر والمستمعين إليه تشوقاً كأن ما جرى فيلم سينمائي مثير. وما يزال أهل الحي يحللون الأسباب وصولاً إلى النتائج دون أن يعرفوا كثيراً من الحقيقة حتى لا يبقى أحد جاهلاً بما جرى. ويعيش الحي أياماً جميلة على هذه الأخبار المتناقَلة. فإذا سمعتَ من أحدهم أسفاً على ما جرى فاعلم أنه كاذب بمقدار ما هو متمتع.
ذلك هو الصراع المسرحي. فالمسرح نموذج أو محاكاة أو صورة للحياة. وأشدُّ إثارات الحياة هو الصراع. وما ذلك إلا لأن الحياة البشرية نفسها قامت منذ الأزل على الصراع بين الناس كما قامت على الصراع مع الطبيعة. فكانت الحروب أشد أنواعها عنفاً وقسوة لم يردعا البشرية بعد قرون متطاولة عن شرورها. وكان اختراقُ الجبال وتمهيدُ الأراضي جانباً آخر من الصراع يخلق عند الناس متعة التحدي وفرحة الانتصار. وإذا كان الصراع ضغطاً من جانب يلقى استجابة عند الجانب الآخر، فقد كان وصف الصراع المسرحي بأنه (سجلُّ الضغط والاستجابة) أدقَّ وصف لـه. ولم يكن الصراع في المسرح أجمل عناصره - وإن لم يكن أخطرها - إلا لأنه مستمد من جوهر الإنسان. فكان العنصرَ الأول الذي يتيح لك أن تقول إن المسرح محاكاة للحياة. ويحق لك بعد ذلك أن تفهم المحاكاة على أي شكل تحدّث به المؤرخون والناقدون من أيام أرسطو حتى اليوم. فهي - خلال كل تعريفات المحاكاة وتعقيدات هذه التعاريف- لا تزيد عن تأكيدٍ للصراع المسرحي الذي لا بد فيه من أناسٍ يتصارعون، ومن أسبابٍ للصراع، ومن حكاية معينة أدت إلى الصراع. ولا يزيد الأمر بعد هذا عن ذلك الشجار الذي جرى في زاوية الشارع الهادئ بعد أن يسبغ عليه الكاتب أردية الفن وأوشحة الخيال.
تعريف الفنيَّة في الصراع
وقد أجمعت أوصاف النقاد الجادين للصراع بأنه (علاقة صداميّة بين طرفين). وشبَّه بعضُ ظرفائهم تكوينَه بأن على الكاتب (أن يضع بطله فوق شجرة. ثم يقذفه بالحجارة طوال مدة المسرحية. ثم يُنـزِله عنها في نهايتها).
والصراع غير الخلاف في الرأي وغير المشاحنة. وإنما هو شحنة ملتهبة تضرب المسرحية من أولها إلى آخرها وتوصل المسرحية إلى هدفها النهائي. ولعل أكمل تعريف لـه أنه (تناقض بين قوتين متكافئتين تمارس فيه الإرادةُ وعيَها. ويتجه بالقصة إلى هدفها).
من هذا التعريف تتوضح خصائص الصراع:
آ - أن يكون بين قوتين متكافئتين. فلا لذة في متابعة مباراة رياضية بين فريق قوي وفريق ضعيف. وقد تبدو القوتان في الظاهر غيرَ متكافئتين، كأن يكون الصراع بين رجل أعزل وبين قوة طاغية مدججة بالأسلحة. لكننا نكتشف أن الكاتب شحنهما بما يجعلهما متكافئتين. فحينما أكرهت الكنيسةُ غاليلو غاليلي على إنكار دوران الأرض حول الشمس قال بصوت خافت (مع ذلك فإنها تدور). وعند ذلك تكافأت قوة الكنيسة المسيطرة مع قوة إرادة الرجل الأعزل الفرد.
ب - أن يكون كلٌّ من طرفي الصراع واعياً لمعركته مع الطرف الآخر. وهذا ما يشحذ الإرادة ويعمِّق الصراع ويضع الأقوال والأفعال والمواقف في إحكام التسلسل المنطقي. ولنتذكر أن المسرحية كلها قائمة على مبدأ (السببية). وإدراكُ أطراف الصراع لمواقعها يعدُّ حجرَ الزاوية في بناء المسرحية على السببية. (فأوديب) يدرك أن خصمه هو القدر. والقدر - متمثلاً بالكاهن - يعرف أيضاً ما يريد. و(هملت) يعرف أن خصمه هو عمه الملك فيحاول قتله. والملك العم يدرك أن بقاء هملت في القصر على قيد الحياة سينغص عليه عرشه وحياته الزوجية فيحاول قتله. والدكتور (ستوكمان) في مسرحية إبسن (عدو الشعب) يدرك أن خصمه هو المدينة بأسرها. والمدينة تعرف أن الدكتور ستوكمان يريد حرمانها من مشاريعها الرابحة. وكلٌّ من هذه الأطراف يصارع خصمه بوعي وإصرار عبر مجموعة من الأفعال المترابطة المؤدي بعضُها إلى بعض.
ج - أن يرتبط الصراع بالهدف الأعلى للمسرحية وأن يوصل إليه. وبذلك يظل قائماً وقوياً من أول المسرحية إلى آخرها. ولأنه يتجه إلى هدف معين فإنه يسير في مسار محدد. فيحذف عنه الكاتب كل ما لا يخدم هذا الهدف. ويضيف إليه كل ما يخدم الهدف.
وجمال الصراع في المسرحية أن أحد الطرفين يبدو متفوقاً على الآخر فيسمى (القوة المسيطرة المهاجمة) ويكون الثاني (مدافعاً) عن نفسه أمام الأول. فكأن الطرف الثاني واقف على حافة الهاوية وأنه سيسقط في اللحظة التالية. فتثور لذة المتابعة عند المتلقي، قارئاً للنص أم مشاهداً للعرض، خوفاً على الطرف المدافع. وتزداد لذته عندما يجد أن المدافع رغم طغيان خصمه يصمد أمامه. حتى إذا انتهت المسرحية بانتصار المدافع انفرجت أساريره. وإذا انتهت بانتصار المهاجم المسيطر ركبه الحزن اللذيذ. فالقدر أقوى من (أوديب). والكنيسة أقوى من غاليلو غاليلي. وعداءُ الأسرتين الكبيرتين أقوى من روميو وجولييت. وهؤلاء الضعاف لا يريدون التحرش بهذه القوى الطاغية. لكنها هي التي تهاجمهم وهم يدافعون عن أنفسهم. وعند دفاعهم تبرز مكامن قوتهم. فتبرز قوة الإرادة عند أوديب وغاليلي. ويتجلى الحب عند روميو وجولييت.وما أمتع متابعة هذا الصراع الذي يقف فيه الطرف المحبوب على شفا الانهيار في حين يبدو الطرف المكروه على شفا النصر طوال مدة العرض. فإذا انتصر القدر على أوديب خرج المتلقي وهو يحمل ذلك الحزن الشفيف الذي يزداد رقة وعمقاً بموت الحبيبين الشابين روميو وجولييت.
والأمتع في الصراع أن تتبادل القوتان المواقعَ في سير الحكاية. فتبدو إحداهما مسيطرة في لحظة ثم تصبح مدافعة في لحظة أخرى. وبهذا الانتقال تلهث أنفاس المتفرجين وهم يتابعون هذا الانتقال. وهذا النوع من الصراع هو الأكثر شيوعاً في النصوص المسرحية وهو الذي يتلاعب بواسطته الكتابُ بعواطف قرائهم ومشاهدي عروض نصوصهم.
والمتفرج في متابعة هذا الصراع ينحاز إلى أحد الطرفين. وانحيازه يعني بالضرورة تأييداً لأفكاره وقيمه التي تعرَّض للصراع من أجلها. وبهذا الانحياز يصل الكاتب إلى إيصال الهدف الأعلى للمسرحية. ولا يوجد شيء أقوى من هذا الأسلوب في غرس الأفكار والحقائق والنـزعات الإنسانية في نفوس المشاهدين والقراء. ولذلك كان المسرح أقوى نوع أدبي في الانتصار للحق والخير والجمال.
والصراع - بخصائصه التي ذكرناها وبأنواعه وبدوره - كان يتخذ شكلين لكل منهما جمالياته ولذائذه. الأول منهما صريح واضح ظاهر يزجُّ حكاية المسرحية في الغليان. وأكثر المسرحيات تتخذ هذا الشكل لأنه يستطيع إثارة جميع الناس مهما اختلفت ثقافاتهم وبيئاتهم. ومسرحيات شكسبير وموليير وراسين وإبسن من هذا الصنف. وهو صنف ناري عاصف. وقد حفَل به الكثير من المسرحيات العربية المكتوبة في النصف الثاني من القرن العشرين. فلا نكاد نعرف الخلاف بين الخليفة والوزير في (مغامرة رأس المملوك جابر) لسعد الله ونوس حتى يزج بنا الكاتب في حومة صراع قوي واضح لا لَبْسَ فيه. ولا نكاد نرى (السجين 95) لعلي عقلة عرسان حتى يحتدم الصراع واضحاً جلياً بين ثابت ومثبوت. ومثل ذلك يحدث في (مأساة الحلاج) لصلاح عبد الصبور. فما يكاد الحلاج يدلي ببعض آرائه وأقواله حتى نكتشف طرف الصراع القوي الذي يشنه عليه بعض الفقهاء. وهو صراع مازال يحتد حتى يوصل الحلاج إلى المحكمة ثم إلى الحكم بالإعدام. وفي (ليالي الحصاد) لمحمود دياب، تبرز أنياب أهل القرية بمجرد الحديث عن الفتاة. وما يزال يتصاعد حتى ينتهي إلى المأساة.
أما الصنف الثاني فالصراع فيه ساكن هادئ يكاد لا يظهر. فهو صراع نفسي وفكري أكثر مما هو صراع عملي. ومن هذا الصنف أكثر مسرحيات
تشيخوف والمسرح الأمريكي الواقعي في منتصف القرن العشرين الذي كتب فيه تينيسي ويليامز وآرثر ميللر مسرحياتهما. وهو صراع يحتدم في النفوس والعلاقات الخفية بين أشخاص عقدت بينهم أواصر القرابات واختلفت بهم وجهات النظر. وهو لا يكون صراعاً مجسداً على الخشبة بوضوح وجلاء، بل يكون احتداماً في النفوس. ولا بد أن يتجلى في بعض المواضع من الحكاية. لكنه سرعان ما يرتد إلى داخل النفس. وهذا الصنف، رغم سكونه الظاهري، عميق مستمر قوي. ويحصد منه المتلقي متعة عقلية وعاطفية فائقة وإن كانت هادئة. لكنه يبدو بارداً في العرض المسرحي مهما برع الممثلون في إظهار خفاياه. وهو، لذلك، لا يكون شعبياً في العرض أو ممتعاً في القراءة إلا لقلة من الناس.
وفي كلا الصنفين لا بد للصراع أن ينتهي إلى خاتمة هي في الوقت نفسه خاتمة المسرحية. وليست الخاتمة إلا استقراراً لـه على شكل من الأشكال. وفي لحظة انتهاء الصراع يكون الكاتب قد قدم موقفه من الحياة والعالم وأجاب على جميع التساؤلات التي طرحتها الشخصيات وألقتها إلينا الحكاية. فإذا أبقى الكاتب صراعه مفتوحاً مستمراً في المستقبل الذي يأتي بعد انقضاء زمن الحكاية، فإنه يترك للقارئ أو المشاهد أن يحسم الصراع كما يشاء. فكأنه يُبقي تساؤلاته مفتوحة عند المتلقي. لكن صراع الحكاية يكون قد انتهى وبدأ صراع جديد يكون المتفرج أو القارئ مسؤولاً بنفسه عن احتدامه واستمراره.
هذا الوصف للصراع هو ما يمكن أن نسميه النوع التقليدي منه. وهو الذي ظل الكتاب المسرحيون طوال القرون يجوِّدونه ويطوُّرونه ويسعون إلى تحميله كل عناصر الإثارة في صعودٍ يتنامى مع تطور الحكاية. لكن القرن العشرين أجرى عليه تعديلاً بسيطاً وحاسماً. ففي المسرح الملحمي ذي الشكل الروائي، والذي يبني المسرحية على طريقة المشاهد المتتالية ولا يبنيها على طريقة المشاهد المتراكب بعضُها فوق بعض، لا يمكن تحقيق الصراع المتصاعد القوي الحازم الحاسم، بل يبدو على شكل تناقض بين الشخصية وبين العالم أو بينها وبين من حولها. ولعل (الأم شجاعة) أفضل مثال على هذا الصنف. فهي لا تصارع أحداً ممن حولها. لكنها تختلف مع الجميع لأن فكرتها عن العالم تناقض ما يجري حولها. وهذا التناقض يتم بينها وبين أقرب الناس إليها وهم أبناؤها الذين لا يصارعونها بل يختلفون معها. وهذا التناقض الدائم بين الشخصية وبين العالم هو الذي يُبرز لنا العالم على الصورة التي يريدها الكاتب.
وتم التعديل الثاني في مسرح العبث. فلأنه لا شيء يحدث فإن الصراع لا يتولد ولا يحتدم. وتبدو الشخصيتان المتحاورتان في (انتظار غودوت) وكأنهما متفقتان. ومن خلال هذا الاتفاق الظاهري يبرز التناقض بينهما وبين العالم. فكأن البريختية والعبثية - رغم تناقض أهدافهما - تضعان الصراع في كفتين جديدتين متشابهتين. وكان هذا أمراً طبيعياً. فكلا المنهجين انبثق عن الرغبة في تحطيم الدراما التقليدية.
إن الصراع هو النسيج الضامُّ لجميع أركان التأليف المسرحي. وهو الذي يحول أجزاء الحكاية التي تقوم بها شخصياتها، إلى عمل مسبوك محبوك مثير. وقد تغير تناول بقية عناصر التأليف المسرحي. فجرت تعديلات كثيرة على بناء الشخصية. وثار الكتاب على الحبكة وأيدهم النقاد أحياناً في الثورة عليها. لكن الصراع هو العنصر الوحيد الذي لم يتغير ولم تتبدل مظاهره. وكل ما حدث لـه أن أطرافه تغيرت وأن أنواعه ازدادت وتعمقت. فسواء كان الصراع بين البشر والآلهة، أم كان بين نبلاء القوم حين تمزقهم المصالح والرغبات، أم كان بين أشخاص يصارعهم أفراد، أم كان في أعماق النفس الواحدة، فقد ظل مسارُ الصراع في بناء المسرحية واحداً لم يتغير ويبدو أنه لن يتغير. ومهما تنوعت أساليب المدارس الأدبية واتجاهات الكتابة، فقد ظل الصراع المسرحي العصب الحساس الذي لا يمكن أن يُستغنى عنه. وشرطه الأول أن يكون قوياً ضارياً بين كفتين متوازيتين ومتوازنتين. وشرطه الثاني أن يكون صاعداً متواتراً دون تلكؤ أو استرخاء. وشرطه الثالث أن لا يغيب لحظة واحدة عن مجريات الأحداث وتصرفات الشخصيات. فإذا تخلى الصراع عن هذه الشروط الثلاثة في مشهد أو موقف، وقع ذلك المشهد أو الموقف في وهدة الضعف والتراخي. فيقعان مباشرة في الإملال. أما إذا افتقد النص المسرحي كله هذا العنصر الحار فلا شيء قادر على إحياء النص حتى إن اكتملت لـه بقية العناصر.
الرؤية الاجتماعية في الصراع المسرحي:
وافتقاد الصراع المسرحي أو تراخيه أو غموض أطرافه هو الداء العضال الذي وقعت الكتابة المسرحية العربية في براثنه منذ بداية تسعينات القرن العشرين. وهو أحد الأسباب الأساسية في غياب النصوص العربية عن خشبة المسرح وفي تناسي المخرجين لها. ونعترف أن هذا الوقوع كان نتيجة منطقية لمعطيات العصر الحاضر. ذلك أن الصراع المسرحي لا يتحول إلى براعة فنية إلا إذا كان مدعوماً برؤية اجتماعية واضحة.
إن الأدب في جميع أشكاله كان وما يزال صورة عن الواقع الاجتماعي لا في حالته السكونية بل في حركته المتطورة المتغيرة. وأعظم الآثار الأدبية كُتبت في فترات الانقلابات الكبيرة التي كانت تعصف بمجتمعاتها وتنتقل بها من حال إلى حال. وفي هذه الفترات كان الأدب المسرحي أقدرَها على تصوير المجتمعات في حركتها الانقلابية تلك. وفي مثل هذه المنعطفات كانت قوى المجتمع دائماً تتصارع بين قديم يحاول أن يتشبث بالبقاء وبين جديد يحاول أن يفرض نفسه نهجاً جديداً في الحياة. وفي مثل هذا الصراع الاجتماعي الكبير يصبح الصراع المسرحي قوياً بقدر قوة صراع القوى في المجتمع. ولنتذكر نصوص شكسبير وموليير وراسين وإبسن وبريخت وغيرهم من الكتاب المسرحيين الذين امتازوا بقوة الصراع المسرحي رغم انتماء هؤلاء إلى مدارس وعصور ومجتمعات مختلفة. لكنهم جميعاً عاشوا في فترات انقلابية اقتصادياً واجتماعياً. ولنتذكر أيضاً النصوص العربية التي كتبت منذ بداية المسرح العربي حتى نهاية منتصف عقد ثمانينات القرن العشرين. فقد كُتِبت هذه النصوص في فترة معاركة الاستعمار في النصف الأول من القرن العشرين، وفي فترة معاركة أوضاع التخلف والاستبداد والاستغلال التي أعلنت الثورات العربية لواء الحرب عليها في نصفه الثاني. وامتازت هذه النصوص بقوة واضحة في صراعها المسرحي. وإذا كانت نصوص النصف الأول من القرن العشرين تخسر الكثير من عناصر الكمال الفني، فإنها جميعاً كانت تمتاز بوضوح كفتي الصراع فيها وبقوة المجابهة بين هاتين الكفتين لأن الكتاب المسرحيين الذين كانوا يجهلون الكثير عن عناصر وأركان التأليف المسرحي، كانوا يدركون - بحسهم الفطري - أن الصراع هو الجوهري في المسرح وأنه الحامل لأفكارهم وشريكُهم في معاركهم السياسية والفكرية. أما نصوص النصف الثاني من القرن المذكور فقد استكملت عناصر البناء الفني التي كان الصراع واحداً من أبرزها وأقواها. وكان دائماً صراعاً ضارياً عنيفاً. فكأن وضوح الصراع الاجتماعي يعطي وضوحاً في الصراع المسرحي. وكأن قوة الصراع الاجتماعي تعطي قوة في الصراع المسرحي. وبذلك نصل إلى النقطة الجوهرية في صناعة المسرح على الخصوص وهي أن بناء الصراع المسرحي ليس جانباً فنياً يبرع فيه الكاتب، بل هو أيضاً رؤية واعية لحركة المجتمع. وعندما تغيم الرؤية الاجتماعية يتخاذل الصراع المسرحي فيفقد شروطه الثلاثة كلها دفعة واحدة. وها هي النصوص المسرحية العربية اليوم يكتبها كتاب ملكوا ثقافة عالية في أركان التأليف المسرحي. وعرفوا قيمةَ وأثرَ الصراع في بناء المسرحية. لكن صراعهم يتخاذل ويضعف لأن الواقع العربي اليوم غائم الملامح. صحيح أن لـه أهدافه الواضحة المتمثلة في بناء مستقبل مشرق يعيش فيه الإنسان العربي بكرامة المواطن وعزة الوطن، لكن الطريق إلى تحقيق هذه الأهداف غامضة. وبذلك يتحول الحلم الواضح في الذهن والخيال إلى هيولى الواقع وضبابية المنظور. فيقف الأديب حائراً إلى أين يوجه خطوات ما يكتب حين ينشد الشعر أو يحكي الرواية أو يصور الأحداث في المسرحية. وإذا كان الشعر يقع في الفتور مع غياب الرؤية، وتتحول الرواية إلى سرد مع ضبابية النظرة، فإن المسرحية تفقد قوة الصراع المسرحي. وسوف نعود إلى هذه النقطة عند مناقشة (الموضوع في المسرح)
إن الصراع المسرحي المتقن المتصاعد هو روح المسرحية. فإذا وجد هذا الصراع القوي في نص ما فسوف تتهافت الفرق المسرحية عليه. وسوف يحتل مكانته رغماً عن الجميع، شريطة أن يحمل رؤية اجتماعية صحيحة يجد فيها القارئ أو المتفرج نفسه وعصره لا في حالته السكونية الحالمة العاجزة عن تحقيق الحلم، بل في حالته المتحركة الفاعلة في تحقيق الحلم.
ملامح الصراع المعاصر
ولكن.. ما هي الصيغة البنائية التي يمكن أن يستقر عليها الصراع المسرحي في النصوص التي يكتبها أو سيكتبها الكتاب العرب اليوم وفي العالم؟ هل يمكن التخلي عن أحد شروطها أو خصائصها مع قولنا إن الصراع المسرحي هو الركن الوحيد الذي لم تتغير شروطه وخصائصه، ورغم قولنا إن التعديلات الذي حدثت عليه في القرن العشرين لم تخرج به ركناً أساسياً في النص المسرحي؟
للإجابة على السؤال نذهب إلى الموسيقى ففيها مفتاح الدخول إلى الصراع اليوم.
يذكر علماء الموسيقى العربية أن ضروبها الإيقاعية تزيد عن سبعين ضرباً. منها الطويل البطيء مثل (المحجَّر) ووزنه 14 على 4، و(السماعي الثقيل) ووزنه 10 على 8. ويفتخر هؤلاء العلماء بهذا الرقم الكبير للإيقاعات العربية التي يزيدها البعض إلى أكثر من هذا الرقم. وكان الكثير من هذه الإيقاعات مستخدماً في الموسيقى العربية في بداية القرن العشرين. وكان بطؤها وتنوعها يخلقان نشوة الطرب الأصيل الذي ما نزال نتغنى به. لكن الإيقاعات البطيئة الطويلة بدأت تنحسر عن الألحان منذ منتصف القرن العشرين لأن طولها وبطأها صارا مملين. وحافظ الموسيقيون على نوع متوسط البطء والطول مثل (المصمودي) ووزنه 4 على 4. فلما عصفت السرعة بالموسيقى في السنوات الأخيرة، انحسرت جميع الإيقاعات الطويلة ونصف الطويلة. وهرع الموسيقيون إلى الإيقاعات السريعة التي تشكل (الوحدةُ القصيرة) عمادَها الأساسي. وأضاف الموسيقيون إيقاعاتٍ غربيَّة أشد سرعة وصخباً. ورغم كل مناداة المفكرين بالعودة إلى الأصالة العربية في الموسيقى وإلى التراث الغني، فإن الإيقاعات السريعة العنيفة تجتاح الموسيقى المعاصرة لأنها تلبي سرعة العصر واختصار الزمن فيه. ولو تجرأ أحدهم على العودة إلى الإيقاعات الطويلة البطيئة أو نصف الطويلة لما لقي إلا الإهمال والتثاؤب والملل. وأعتقد أن الإيقاعات الطويلة اندثرت في هذا العصر ولم يعد من الممكن إحياؤها مهما صرخ عتاة الموسيقى والمدافعون عن أصالة الموسيقى العربية. فلن يكسبوا من وراء ذلك إلا أن يجرحوا أصواتهم التي يطلقونها في صحراء فارغة.
إن الصراع المسرحي لا يتغير. وأشكالُه موجودة معروفة. لكن بعض أشكاله بدأت تندثر. وعلى الكتاب أن يتجنبوها كما يتجنبون الداء العضال. فالصراع الساكن الهادئ العميق الذي بُنيت عليه مسرحيات تشيخوف مثلاً، صار السيرُ على منواله سقماً ومللاً. وإذا كانت إنكلترا وأمريكا قد افتُتِنت بهذا الصراع مع بداية القرن العشرين ونهجت على منواله في نصوص الواقعية الأمريكية، فإن الصراع في هذه المسرحيات لا يقل إملالاً عنه في مسرحيات تشيخوف. ولا يعني هذا طعناً بمسرحيات الصراع الساكن أو انتقاصاً من قيمته. لكن هذا النوع صار مثل إيقاعات الموسيقى العربية البطيئة التي هجرها العصر الحديث وتجنبها الموسيقيون لكي يملؤوا موسيقاهم بالسرعة والصخب. ولا يعني هذا أيضاً إلغاءَ هذا الصنف من الصراع وإلا كان ذلك سخفاً وجهالة. فلا يمكن لأحد أن يلغي نوعاً من الصراع قامت عليه نصوص عظيمة ويمكن أن تقوم عليه نصوص عظيمة. ولا يعني هذا أيضاً ثانياً أن نفرض على كتاب المسرح أساليب معينة في الكتابة وإلا كان ذلك أشد سخفاً وجهالة. وإنما يعني أن على الكاتب أن يعرف نبضَ العصر الذي يعيش فيه، وأن يدرك مكامن الإثارة النفسية والعاطفية والفكرية التي تشحذ عقل المتلقي وقلبه. وبما أن نبض العصر اليوم سريع حاد، فلا سبيل أمام الكاتب في الساعة ونصف الساعة التي هي الزمن المتاح لـه، إلا أن يكون صراعه سريعاً حاداً كأنه الشهاب الناري.
وإذا كان على الكتاب أن يتجنبوا الصراع الساكن الهادئ، فإن عليهم أن يتجنبوا (التلكؤ) في إدارة الصراع. فالكتاب المسرحيون - فيما سبق تسعينات القرن العشرين - كانوا يتمهلون في بعض المشاهد لإلقاء بعض الأفكار. فكان الصراع يتوقف عن الصعود الحاد. وكان ذلك أمراً مرغوباً في المسرح. أما اليوم، فإن هذا التمهل صار تلكؤاً. وصار هذا التلكؤ أحد مقاتل النصوص المسرحية. أما أفكارهم وتوجهاتهم فيجب أن تأتي من خلال حرارة الصراع نفسه. وسوف نقف عند هذه النقطة وقفة أطول فيما يأتي من البحث.
وهنا نصل إلى قضية كانت مؤرقة لنقاد المسرح وللكتاب على حد سواء وهي قضية (الميلودراما) في الصراع المسرحي. فقد اتفق أكثر النقاد على رفضها، واتهموها بأنها (إثارة عنيفة للعواطف). وبأنها (عندما تطرح صورة الرذيلة والشر في المجتمع فإنها لا تقدم أية تفسيرات لهما. وتربط زوالهما بتدخل العناية الإلهية أو بالقدرات الفردية للبطل. وقد اعتبر الفيلسوف الألماني كارل ماركس الميلودراما اختراعاً قدمته البرحوازية للشعب، تماماً كما قدمت لـه الملاجئ الخيرية ووجبة الحساء اليومية).([6]) وعدوها نوعاً كريهاً في المسرح، وطلبوا من الكتاب أن يتجنبوها، ووصموا المسرحيات التي تقوم عليها بالضعف في أكثر الأحيان.
أما أنها إثارة عنيفة للعواطف فأمر صحيح. وأما أنه مضى عليها ردح من الزمن كانت عليه كما وُصفت فأمر صحيح أيضاً. وأما أنها نوع كريه في المسرح فأمر باطل. وأما أن الكتاب تجنبوها فأمر لم تثبت صحته. وأما أن المسرحيات التي تقوم عليها ضعيفة فأمر ثبت عكسه. وأما أنه يُطلَب أن نستخدمها أسلوباً حيوياً في الصراع بعد أن نخلصها من عيوبها ونحافظ على حسناتها، فأمر سيجد الكتاب أنفسهم مرغمين عليه لأنه الملاحة والإثارة من ناحية، ولأنها إسراع في احتدام الصراع من ناحية ثانية.
إن كبريات المسرحيات قامت على الإثارة العنيفة للعواطف. وماذا نسمي المبارزات وجرائم القتل التي احتشد بها مسرح شكسبير؟ أليست لحظةُ شرب روميو للسم بعد ظنه بموت جولييت أقصى درجةٍ من لحظات إثارة العواطف بالعنف؟ أليس إلقاءُ الأحجار على بيت الدكتور ستوكمان في مسرحية إبسن (عدو الشعب) من أرهف لحظات إثارة العواطف بالعنف؟ أليست لحظة قراءة الرسالة التي على رأس المملوك جابر ثم قطع هذا الرأس واحدةً من اللحظات الفريدة في المسرح العربي؟
إن الميلودراما المفترى عليها واحدةٌ من أمضى أسلحة الكاتب المعاصر. ففي عصر الإثارة بملاحقة السيارات في الأفلام والسينما وبأمثالها من مواقف التوتر النفسي والعاطفي فيما حولنا من ظروف العصر، تصبح الميلودراما ملحَ المسرح. وقد آن الأوان لنرد للميلودراما مكانتها في النقد. خاصة وأن الكتاب استخدموها بشراهة فيما مضى من تاريخ المسرح. وآن أن نعلن عن تلذذنا بها وأن نحثَّ الكتاب عليها. فهي الفتنة والإثارة. وهي التشويق الممتع. وهي لحظات التجلي الأكبر للعواطف حين يحتدم الصراع بين النوازع الدفينة في نفوس البشر. وأعتقد أن خلو النصوص المسرحية العربية من الصراع القوي ومن اللحظات الميلودرامية فيه، كان ذا أثر كبير في ضعف هذه النصوص. وأعتقد أن العودة إلى الصراع القوي بإثارته العنيفة للعواطف سوف يعيد إليه مكانتها السابقة على خشبات المسارح.
لكن الميلودراما لا تصبح سلاحاً ماضياً في يد الكاتب إلا إذا تجنب النوع الكريه منها وهو القفز إليها بغية الإثارة الفارغة. وليس المقصود منها أن يلجأ الكاتب إلى ما يشبه ألاعيب السينما، بل أن يستفيد الكاتب من قدرتها على الإثارة وأن يأتي بها مقنعة للمتلقي في تسلسل الوصول إليها. فإن القفز إليها دون تمهيد يدعو إلى السخرية لأنه افتعال إذ تصبح حدثاً لا مسوغ له.
إن قراءة المسرحية أو مشاهدتها يجب أن تكون شيئاً ممتعاً يدفعنا إلى ارتياد المسرح بتشوق. ولن يتحقق لـه هذا التشويق إلا بإدارة صراع مثير يلهب العواطف ويحرك العقول ويرعش القلوب. والصراع المسرحي هو المفتاح لذلك دون أن ينسى الكاتب أن كل وسائل الإثارة والفتنة لدى القارئ أو المشاهد لا بد أن توضع في شكل فني يقدم رؤية فكرية للمجتمع. فبهذه الطريقة يتكامل شِقّا الصراعِ بأنه براعة فنية ورؤية اجتماعية.
إن كتاب المسرح اليوم هم أبناء هذه المرحلة بأحلامها وعجزها، بطموحها وضبابيتها. فعليهم، إذا أرادوا أن يكتبوا النص المسرحي القوي، أن يعيدوا النظر لا بمعرفتهم المتينة لعناصر التأليف المسرحي فحسب، بل وبفهمهم للمجتمع وبمعرفتهم للقوى الفاعلة فيه. وعليهم أن يكونوا هداةَ الناس في حياتهم. وعليهم أن يضيئوا للناس طريق مستقبلهم. وبكلمة موجزة: أن يكونوا الشاهد على العصر كما كان الكتاب المسرحيون قبلهم.
([1]) - كتاب (نشوء الرواية) تأليف "إيان واط" ترجمة عبد الكريم محفوض. إصدار وزارة الثقافة – دمشق – 1991.
([2]) - كتاب (من تاريخ الرواية) تأليف حنا عبود. إصدار اتحاد الكتاب العرب – دمشق – 2002- ص 8.
([3]) - كتاب (تاريخ الرواية الحديثة) تأليف ر. م. ألبريس. ترجمة جورج سالم منشورات بحر المتوسط وعويدات - 1982
([4]) - كتاب حنا عبود (من تاريخ الرواية) ص 11.
([5]) - (إعداد الدور المسرحي) تأليف قسطنطين ستانسلافسكي - ترجمة الدكتور شريف شاكر. إصدار وزارة الثقافة - دمشق عام 1983- ص 67 - 68
([6]) - (المعجم المسرحي) تصنيف د. ماري الياس ود. حنان قصاب حسن. إصدار مكتبة لبنان – بيروت- 1997 ص 498.

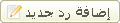
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه